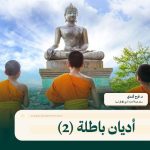
أديان باطلة (2) – عقائد الهند نموذجاً
سبتمبر 12, 2025
غارات الاحتلال تستهدف ثلاث مدارس بمخيم الشاطئ
سبتمبر 13, 2025د. يوسف القرضاوي رحمه الله
ذلك أنه يرى المنكر يستعلن، والفساد يستشري، والباطل يتبجح، والعلمانية تتحدث بملء فيها، والماركسية تدعو إلى نفسها بلا خجل، والصليبية تخطط وتعمل بلا وجل، وأجهزة الإعلام تشيع الفاحشة، وتنشر السوء. يرى النساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، ويرى الخمر تُشرب جهاراً، وأندية الفساد تجعل الليل نهاراً. يرى المتاجرة بالغرائز على أشدها، من أدب مكشوف، وأغانٍ خليعة، وصور فاجرة، وأفلام داعرة، وتمثيليات ومسرحيات ووو.. كلها تصب في نهر الإغراء بالفسوق والعصيان، والتعويق عن الإسلام والإيمان.
يرى المسلم هذا في ديار الإسلام، ويرى معها التشريع الذي يجب أن يعبر عن عقائد الأمة وقِيَمها في صورة قوانين تحرس معنويات الأمة، وتعاقب من يجترئ على حماها.. هذا التشريع للأسف يبارك المنكر، ويؤيد الفساد، لأنه لم ينبع مما أنزل الله، بل مما وضع الناس، فلا عجب أن يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، ويُسقط فرائض الله، ويعطل حدود الله.
ثم يرى الحكام الذين حملهم الله المسؤولية عن شعوبهم المسلمة يسيرون في وادٍ غير وادي الإسلام، يوالون من عادى الله، ويعادون من والى الله، ويقربون إليهم من بعّد الله، ويبعّدون من قرب الله، ويقدمون من أخّر الإسلام، ويؤخرون من قدمه، ولا يذكرون الإسلام إلا في الأعياد والمناسبات، تمويهاً على شعوبهم، وضحكاً على لحاهم!
ومن ناحية أخرى، يرى الظلم الاجتماعي البيّن، والتفاوت الطبقي الفاحش، أفراد يلعبون بالملايين، وجماهير لا يجدون الملاليم، قصور تُشاد وتُنفَق عليها عشرات الملايين، وربما لا تُسكن في السنة إلا أياماً معدودات، على حين يموت ملايين في العراء، لا يجدون ما يحميهم من حر الصيف ولا برد الشتاء؛ أناس تموج خزائنهم بالذهب كما يموج التنور باللهب، وأرصدتهم في البنوك الأجنبية بأرقامها السرية، لا يعلم مقدارها إلا الله والكرام الكاتبون، والخواجات الحاسبون؛ وسواد الناس ليس لهم خزائن إلا الجيوب التي كثيراً ما تشكو الإفلاس والخواء.. فهي قانعة بالقليل، ولكنه لا تجده، منشدة قول أبي العتاهية:
حسبك مما تبتغيه القوتُ.. ما أكثر القوت لمن يموت!
ومع هذا لا تجد ما تشتري به القوت يسد جوعة الأطفال يصرخون، أو الكبار يتألمون، ولو تبرع وجيه أو ثري من أثرياء النفط، أو أثرياء الانفتاح، أو وسطاء الشركات العالمية! بما يكسبه في صفقة، أو يخسره في ليلة على المائدة الخضراء، أو ينفقه تحت أقدام شقراء، لأغنى الكثير من الفقراء، وأشبع الكثير من الجياع، وكسا الكثير من العراة.
وكيف لا، والثروات الضخمة تُجمع بل تُنهب، والأموال العامة تُسرق بل تُغصب، والرشوة لها سوق بل أسواق، والمحسوبية قائمة على قدم وساق، واللصوص الكبار يتمتعون بالحرية والتكريم، واللصوص الصغار وحدهم يتعرضون للعقاب الأليم! وداء الحسد والبغضاء بين الأفراد والفئات -نتيجة لهذا التظالم- يفتك بالقلوب والعلاقات، فتك الأوبئة بالأجسام؛ ودعاة المبادئ الهدامة يستغلون هذا المناخ وتناقضاته الصارخة، ليؤججوا نار الصراع الطبقي، والحقد الاجتماعي، تهيئة لنشر مذاهبهم المستوردة، فيجدوا في هذا الجو الأذن التي تسمع، لا حباً في المذهب المنشود، ولكن كرهاً للواقع المشهود.
وأساس هذا كله: أن الإسلام -بشموله وتكامله وتوازنه- غائب عن الساحة، غريب في أوطانه، منكور بين أهله، معزول عن الحكم والتشريع، وعن توجيه الحياة العامة، وشؤون الدولة في سياستها واقتصادها، وسائر علاقاتها بالداخل والخارج.. وفرض على الإسلام أن يتقوقع في العلاقة بين المرء وربه، ولا يتجاوزها إلى العلاقات الاجتماعية، أو الدستورية، أو الدولية.
ومعنى هذا أنه فرض على الإسلام أن يكون نسخة من النصرانية في عهد انكماشها، أي: يكون عقيدة دون شريعة، وعبادة دون معاملة، وديناً دون دولة، وقرآناً دون سلطان.
المشكلة ترجع في جوهرها إلى فرض (العلمانية) على المجتمع الإسلامي، وهي اتجاه دخيل عليه، غريب عنه، مجافٍ لكل مواريثه وقيمه، فإن محصلة العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، وإبعاده عن الحكم والتشريع، وهذا لم يعرفه الإسلام في تاريخه قط، إذ كانت الشريعة هي أساس الفتوى والقضاء في الأمة الإسلامية طول عصور تاريخها، وكان الإسلام مصدر العبادات والمعاملات والآداب والتقاليد بين الناس.
قد يوجد من شذ عن ذلك من الحكام والمحكومين، من اتبع الهوى، وانحرف عن الهدى ودين الحق، ولكن لم يوجد قط من يجحد الإسلام شريعة يرجع إليها المختصمون، ويتحاكم إليها المختلفون. حتى الطغاة والجبابرة المتسلطون من أمثال: الحجاج بن يوسف وغيره، إذا ووجهوا بأحكام الشرع، ونصوص القرآن والسنة، لم يملكوا إلا أن يقولوا: صدق الله ورسوله ﷺ، سمعنا وأطعنا.
وفرق كبير بين أن تميل عن صراط الشريعة وعدلها، بدافع من شهوة أو غضب، أو حسد أو غفلة، أو نحو ذلك، وبين أن تجمّدها ولا تعترف بها، ولا تقر بأن لها السيادة، ومن حقها الحكم، لأنها تمثل كلمة الله، وحكم الله، وكلمة الله هي العليا، ﴿ومَنْ أحْسن مِن الله حُكْمًا لقومٍ يوقِنون﴾ [المائدة: 50].
فلا غرو أن تصدم هذه المشكلة بعنف وجدان الجيل المسلم، وتقلق ضميره، حيث يجد الأمم الأخرى تكيف حياتها وفقاً لعقائدها وفلسفاتها وتصوراتها عن الدين والوجود وعن الله والإنسان، ويجد المسلم وحده مكتوباً عليه أن يعيش في صراع بين عقيدته وبين واقعه، بين دينه وبين مجتمعه.
فإن الإسلام عقيدة وشريعة، ونظام كامل للحياة، وبهذا يعني قبوله العلمانية اطراح شريعة الله، ورفض أحكام الله، واتهام هذه الشريعة بأنها لا تصلح لهذا الزمن.. واتخاذ البشر شرائع لأنفسهم من وضع عقولهم، معناه: تفضيل علمهم المحدود وتجاربهم القاصرة على هداية الله ﴿قُلْ أأنْتم أعلمُ أمِ الله﴾ [البقرة: 140].
لهذا كانت الدعوة إلى العلمانية بين المسلمين معناها: الإلحاد والمروق من الإسلام. وكان قبول العلمانية أساساً للحكم بدلاً من الشريعة الإسلامية ردة صريحة عن دين الأمة الذي رضيه الله لها، ورضيته لنفسها، والذي فرض عليها أن تحكم بما أنزل الله.
أضف إلى ذلك كله ما لقيه ويلقاه العالم الإسلامي شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً من هجمة شرسة على أوطانه، ومقدساته، وما يُشن على الأمة الإسلامية من حرب لا تخبو نارها: علنية حيناً، وخفية أحياناً، حرب اتفقت عليها كل القوى غير المسلمة: يهودية وصليبية وشيوعية ووثنية، حتى إنها لتختلف فيما بينها كل الاختلاف، ثم نراها تتفق كل الاتفاق إذا هبت ريح الإسلام في صورة دعوة أو حركة أو دولة.
وهل يسع مسلماً يؤمن بالأخوّة الإسلامية، ويعتز بالانتماء إلى خير أمة أُخرجت للناس، ويؤمن بأن المسلمين -وإن اختلفت أوطانهم وألسنتهم- أمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وأن من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم – أن يرى مآسي أمته في كل مكان ويرى إخوانه في العقيدة معرضين للإبادة المادية بالتقتيل والتنكيل، أو الإبادة المعنوية بالتنصير أو التشييع (أي تحويلهم إلى شيوعيين)، أو على الأقل التجهيل والتضليل، ثم يصبح ويمسي قرير العين، ضاحكاً ملء سنّه، نائماً ملء جفنه؟ فأين أخوّة الإيمان، ورابطة الإسلام؟
إن أنباء الصباح والظهيرة والمساء، تحمل إلى المسلم الغيور كل يوم عن إخوانه في فلسطين، أو في لبنان، أو في أفغانستان، أو في الفلبين، أو في إرتريا أو الصومال أو قبرص أو الهند، أو غيرها من البلاد التي يعيش فيها المسلمون أقلية مضطهدة، أو أكثرية مقهوره، ما يزلزل قلبه زلزالاً شديداً، وما يعصر قلبه من الألم عصراً، وما يكوي كبده بالأسى والحسرة كي النار أو هو أشد إيلاماً.
وأهم من ذلك أنه لا يجد من حكومات بلاده الإسلامية تجاوباً مع هذه القضايا العادلة، بل يجد الإعراض عنها، أو التعتيم عليها، أو الوقوف مع خصومها، وتغليب المصلحة الإقليمية الضيقة، أو الاعتبارات العرقية الجاهلية، أو الارتباطات والولاءات للمعسكرات المختلفة، على الولاء لله ولرسوله ولدينه ولأمته ولقضاياها.
وفوق ذلك كله يقرأ الشباب المسلم ويسمع: أن هذه المواقف السلبية من قضايا الإسلام داخل بلاده، إنما تصنعها القوى المعادية للإسلام خارج بلاده،وأن حكامه ليسوا إلا أدوات في أيدي الصهيونية، أو الصليبية العالمية، أو الشيوعية الدولية، تحركهم من وراء ستار فيتحركون، وتخوفهم من الانتفاضة الإسلامية الفتيّة، فيخافون، ثم تدفعهم لضربها، فيندفعون!
كان من القضايا التي فجرت الكوامن لدى الشباب المسلم في السنوات الأخيرة، ما آلت إليه قضية العرب والمسلمين الأولى بعد النكبة الكبرى في حزيران (يونيو) سنة 1967م تلك التي خففوا وقعها فسموها “النكسة”.
لقد عاش الشباب العربي المسلم، وهو يُلقَّن أن إسرائيل كيان طفيلي دخيل قام على الاغتصاب والعدوان، وأن تحرير أرض الإسلام من هذه الجرثومة الغريبة في جسم الأمة المسلمة فريضة دينية وقومية، وأن لا حق لدولة إسرائيل في البقاء على أرض ليست لها، وكما قال مفتي فلسطين الأكبر الحاج أمين الحسيني رحمه الله: “إن فلسطين ليست بلداً بغير شعب حتى تستقبل شعباً بغير بلد”!
ثم دار الفلك دورته فكانت كارثة 1967م وإذا بالسياسة العربية تتخذ مساراً جديداً كل همه وغايته ليس أكثر من “إزالة آثار العدوان” أي: الاعتراف بإسرائيل، وبكل ما عدت عليه قبل 5 حزيران (يونيه) 1967م ومعنى هذا: أن العدوان الجديد قد أضفى الشرعية على العدوان القديم!
فلماذا كانت حرب 1948م؟ ولماذا كانت حرب 1956م؟ ولماذا كانت حرب 1967م؟ لماذا لم تسلموا لإسرائيل منذ التقسيم، وتريحوا الأمة من أعباء الحرب وخسائرها وويلاتها؟
وجاء السعي وراء ما سمي “الحل السلمي” ومعاهدات السلام مخيباً للآمال ومحبطاً لكل ما كان عند الشباب من توثب وطموح -ومهما برره من برره- بضروات واعتبارات عسكرية أو سياسية محلية أو دولية، فقد كان ذلك صدمة شديدة العنف لأنفس الشباب المسلم وآماله.
وزاد من وقع الصدمة على نفسه أن القوى العالمية الكبرى كلها تؤيد بقاء إسرائيل، مع وضوح حقنا نحن العرب والمسلمين، إنها الصليبية في شكل جديد، هكذا يفكر الشباب ويشعرون، والوقائع تؤيدهم.
هذا الشعور ولا شك، يعمل عمله في أنفس الناشئة المسلمة، الشعور بتلك الروح الصليبية التي لا تزال تحرك الكثيرين من ساسة الغرب وقادتهم إلى اليوم، والنظر إلى العالم الإسلامي وإلى كل حركة إسلامية فيه من خلال الأحقاد الموروثة من عهود الصراع مع أمة الإسلام.
إنه الثالوث الجهنمي الرهيب، يتآمر على أمتنا، وتتداعى علينا قواه كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ثالوث اليهودية والصليبية والشيوعية، الذي اصطلح أهله على حساب وجودنا، وتم وفاقهم على أن يقتسموا المغانم، ويكون علينا المغارم، بل على أن يكونوا هم الجزارين ونحن الضحايا.
أما حكامنا فهم في نظر الشباب “أحجار على رقعة الشطرنج” تحركها وتنقلها من موقع إلى موقع، تلك القوى الخفية التي تحكم العالم! وما الانقلابات التي نشهدها، والتغيرات التي نراها إلا “لعبة” تلعبها تلك القوى على مسرح السياسة تريك الجبان بطلاً يقاتل ويضرب، ويكر ويفر، وهو في حقيقته لا يعرف من أمر الكر والفر شيئاً، إنما هو الخداع والتمثيل.
قد يكون في الكلام بعض المبالغة والتهويل، لكن فيه بعض الحق بالتأكيد، وتدل عليه مواقف ومظاهر شتى، وهو الذي رسّخ في أذهان الكثيرين أن هؤلاء الحكام متآمرون مع أعداء الإسلام على إجهاض الصحوة الإسلامية، وضرب الحركة الإسلامية، حتى لا تبلغ المسيرة غايتها، ولا يؤتي الزرع أكله. فهولاء عند الشباب في الظاهر زعماء وطنيون، على أوطانهم يغازون، وفي الباطن عملاء مأجورون، على دين أمتهم يغيرون، ولحساب أعدائها يعملون!
وسبب آخر لا بد أن ننبه عليه، وهو يتعلق بحرية الدعوة إلى الإسلام والعمل له: فمن المعلوم أن الإسلام لا يكتفي من المسلم أن يكون صالحاً في نفسه، حتى يبذل جهده في إصلاح غيره.
ولهذا كانت فريضة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وكان كل مسلم في نظر الإسلام مكلفاً بالدعوة إلى دينه على قدر طاقته ووسائله. فكل مسلم مخاطب بقوله تعالى: ﴿ادْعُ إلى سبيلِ ربِّك﴾ [النحل: 125] وكل من اتبع رسول الله ﷺ هو داعية إلى الله؛ كما قال تعالى يخاطب رسوله ﷺ: ﴿قُلْ هذِه سبيلي أدْعو إلى الله على بصِيرةٍ أنا ومَنِ اتّبعني﴾ [يوسف: 108].
ولهذا كان شعار المصلحين المجددين: أصلح نفسك، وادعُ غيرك، ﴿ومَنْ أحسنُ قولاً مِمَّنْ دعا إلى الله وعَمِل صالِحاً وقال إنَّني مِن المُسلمين﴾ [فصلت: 33].
والإسلام لا يحب للمسلم أن يعمل وحده، فـ”يد الله مع الجماعة”، و”المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً”، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، والتعاون على البر والتقوى فريضة دينية، وضرورة حيوية، فلا غرو أن يكون العمل الجماعي للدعوة الإسلامية واجباً شرعاً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يؤكد هذا الوجوب أن القوى العقائدية المخالفة تعمل في صورة تكتلات وأحزاب ومؤسسات، فلا بد أن تواجَه بمثل أسلوبها، وإلا بقينا في ذيل القافلة عاجزين أن نصنع شيئاً، وغيرنا يعملون ويتقدمون.
ومن ثَم كان من أكبر الإثم الذي ترتكبه بعض الحكومات في البلاد الإسلامية مصادرة حرية الدعوة إلى الإسلام باعتباره عقيدة ونظام حياة، والوقوف في وجه الداعين إليه، والعاملين لتحكيم شريعته وإقامة دولته، وتوحيد أمته، وتحرير أوطانه، ونصرة قضاياه، وتجميع الناس عليه.
وكان هذا الضغط على الدعوة والدعاة، والتضييق على العمل الإسلامي -وخاصة العمل الجماعي- من أبرز الأسباب التي تدفع إلى التطرف دفعاً، ولا سيما أن الفلسفات والمذاهب الوضعية الأخرى تتمتع بالحرية والمساندة، بلا مضايقة ولا إعْنات.
وليس معقولاً أن يُطلَق العنان في أرض الإسلام لدعاة العلمانية والماركسية والليبرالية وغيرها من المذاهب والفلسفات والأنظمة، وأن تنشأ لها أحزاب ومنظمات، وتنطق باسمها صحف ومجلات.. ويُفرض الحظر على الإسلام وحده، وهو صاحب الدار، وتوضع الكمائم على أفواه دعاته وحدهم، وهم المعبرون عن سواد الشعب، وعن عقائد الأمة وقيمها.
أحرام على بلابله الدوحُ حلال للطير من كل جنس؟!
كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجس!
إن الدعوة إلى الإسلام الإيجابي المتكامل ـعقيدة ونظام حياةـ أصبح بضاعة محظورة، وسلعة مصادرة في عدد من أقطار الإسلام.
والإسلام المسموح به هو الإسلام “المستأنس”، إسلام الدراويش ومحترفي التجارة بالدين، إسلام عصور التخلف والانحطاط.. إسلام الموالد والمناسبات الذي يسير في ركاب الطغاة، ويدعو لهم بطول البقاء! إسلام الجبرية في الاعتقاد، والابتداع في العبادة، والسلبية في الأخلاق، والجمود في التفكير، والاشتغال بالقشور في الدين، دون اللباب.
هذا الإسلام هو المسموح به، المشمول بالرعاية والتأييد من قِبل سلاطين الجور، وحكام السوء، حتى العلمانيون اللادينيون منهم، يحتفون بهذا النوع من التدين ويباركونه، ويظهرون التكريم لرجاله، والتعظيم لدعاته، ليقوموا بدور التخدير للشعوب المقهورة، والطبقات المطحونة، ويغرقوا الشباب في بحار من التهويمات والشطحات، والرموز والمصطلحات، والرسوم والشكليات، مما يخمد روح الجهاد للطاغوت، والمقاومة للظلم، والتغيير للمنكر والفساد.
أما الإسلام الحقيقي.. إسلام القرآن والسنة، إسلام الصحابة والتابعين، إسلام الحق والقوة، إسلام العزة والكرامة، إسلام البذل والجهاد، فهو -كما ذكرنا- مرفوض من جهة أصحاب السلطان، لأنه دائماً يحمل روح الثورة، على ظلم الحكام، وحكم الظلاّم، ويربي أبناءه على أن يكونوا من ﴿الذين يُبلِّغون رِسالاتِ اللهِ ويخْشونَه ولا يَخْشوْنَ أَحَداً إِلّا الله﴾ [الأحزاب: 39] مؤمنين بأن الرزق واحد، والعمر واحد، والرب واحد، فلا محل للخوف إلا منه، ولا الاعتماد إلا عليه سبحانه.




