
القدوة الحسنةالعظمة النبوية في التواصل والإقناع (3)
سبتمبر 6, 2025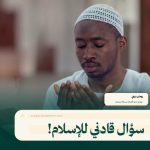
السؤال الذي قادني إلي الإسلام!
سبتمبر 7, 2025عماد إبراهيم
مدير مشروع بصيرة الدعوي
إنما الإسلام دينٌ ** فيه نحيا رُحَماءْ
يُنصف الإنسان مهما ** كان فيه الانتماءْ
فيه تسمو كلّ نفسٍ ** وهو للروح شِفاءْ
إنّه أمر الإلهِ ** وهو إرث الأنبياءْ
الأصلُ في الإسلام: أنَّنا جميعا كمسلمين مأمورون بالدعوة إلى الله تعالى، كلٌّ بحسبه، ولسنا مجرد أتباعٍ لدينٍ عظيم، بل نحن حملةُ رسالة، وسفراءُ نور، ومفاتيحُ هداية، وهذا تشريف من الله لعباده قبل أن يكون تكليف لهم.
ولا يُشترط في ذلك أن تكون عالمًا أو خطيبًا، يكفيك صدقُ الكلمة، وصفاءُ النية، وحُسنُ الخلق.
يُخطئ من يتصور أن الدعوة حِرفة خاصّة بطائفة أو مجموعة من المتخصصين أو مؤسسة ما، أو أنها خطاب نخبوي لا يليق إلا بمن اعتلى المنابر. الأصل الذي يقره القرآن ويؤكده هدي النبوّة أن كلَّ مسلمٍ داعيةٌ إلى الله تعالى، على قدر علمه واستطاعته ومجاله. يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: 33]، ويقول سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125].
ومن سُنّة المصطفى ﷺ قوله: “بلِّغوا عني ولو آية”. وإذا كان هذا هو الحكم العام، فإن “المسلم الجديد” بل قُل ” العائد إلى الإسلام” فهي الكلمة الأدق، فوفقاً للقرآن الكريم نولد جميعاً مسلمين بالفطرة، يتقدم الصفَّ في هذا الباب؛ لأن دخوله في الإسلام حدثٌ فريد ومشهود في حياته، وهو إنسان تربّى في بيئة غير مسلمة أو ضعيفة الارتباط بالدين، ثم اهتدى إلى فطرته الإسلامية؛ فهو أقدر الناس على ترجمة الإسلام إلى لغة قومه، وأقربهم إلى قلوب من عرفوه قبل إسلامه.
إن المسلم الجديد ليس رقماً يُضاف إلى إحصاءات، ولا صورةً تُنشر في مناسبة، بل هو مشروع سفيرٍ للإسلام؛ سفيرٌ يُجيد “الترجمة المزدوجة”: يترجم الإسلام لقومه بحالِه ومقالِه، ويترجم لِلُمَسلمين واقعَ قومه وما يدور في أذهانهم من تساؤلات. ومن ثمَّ فالمسلم الجديد –إذا تعلّم أصول دينه وأحسن معرفة ما لا يسعه جهلُه– فإن من أبلغ وسائل تثبيته وترسيخ الإيمان في قلبه أن يباشر هو نفسه حملَ رسالة الإسلام إلى غيره، داعيًا بالحكمة والقدوة الحسنة. غير أن هذا الباب يظلُّ مرتبطًا بقدرات الأفراد، وظروف البيئات، وتفاوت الأزمنة والأمكنة، فلا يُكلَّف المرءُ فوق طاقته، بل يُراعى فيه اختلاف الأحوال والفروق الفردية.
في السيرة النبوية معالمٌ لا تُمحى
إذ لم يكن المهتدون الجدد إلى الإسلام يُتركون في عزلةٍ أو فراغ، بل يُهيَّؤون لأن يكونوا حملةً للرسالة وسفراء للإسلام، فلما أسلم الطُّفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وأنا راجع إليهم، وداعيهم إلى الإسلام، فادعُ الله أن يجعل لي آية. فقال ﷺ: “اللهم اجعل له آية”. فأذن له بالدعوة وأيّده بالدعاء.
ومن الشواهد أيضاً، عندما أسلم عُمير بن وهب رضي الله عنه ثم قال: يا رسول الله، كنت جاهدًا على إطفاء نور الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله. فأذن له ﷺ فلحق بمكة، فأسلم على يديه الكثير. وكذلك وفدت الوفود من قبائل شتى، فأقاموا عند النبي ﷺ ثم قال لهم رِقّةً ورحمة: “ارجعوا إلى أهليكم فعلِّموهم ومروهم، وصلّوا كما رأيتموني أُصلّي…”. وهكذا يتجلّى أن أقوى دعامةٍ تُحافظ على إيمان المسلم الجديد أن يُعطَى نصيبًا من البلاغ، فيغدو سفيرًا للإسلام بين قومه، ولسانًا ناطقًا ببيانه، وكل هذه الشواهد تُقرِّر أصلًا تربويًا: السيرُ إلى الله يثبت بالقيام بحظٍّ من البلاغ.
ومن هنا يتضح لنا جلياً أن المسلم الجديد لا يقتصر أثره على نفسه، بل يمتدُّ إلى مجتمعه، فهو بين خيارين: إما أن يعتزل بيئته القديمة وينقطع عنها، وإما أن يبقى على صلاتٍ واسعة بأهله وأصدقائه وزملائه، والغالب أنه يظل على صلةٍ وثيقةٍ بمن حوله. وقد أثبتت دراسات ميدانية -أُجريت على عيّنة من المسلمين الجدد- أن نحو 94% منهم بقوا على تواصلٍ مع أصدقائهم من غير المسلمين، وهو ما يكشف عن باب عظيم للدعوة بالقدوة الحسنة والكلمة الطيبة، شريطة أن نُحسن البناء والتوجيه.
لذلك فإن إعداد المسلم الجديد ليكون داعيةً في بيئته وسفيراً لدينه ليس من الرفاهية، بل هو ضرورة لصون إيمانه وتعزيز هُويته. وإن لم يحمل رسالةً -بلسانه أو بسلوكه- خشيَ أن يذوب في مجتمعه أو يُستدرج إلى الانسلاخ عن الدين، بينما الإسلام يأمره أن يعتز بدينه، ويُظهره باعتدالٍ ووقار، فهو الحقُّ الذي لا ريب فيه. وليس مطلوبًا من المسلم الجديد أن يتحوّل في ليلةٍ واحدة إلى خطيب مفوه أو مفتي؛ بل المطلوب أن يكون مؤمنًا يَصدُقُ مع ربّه ويَصدُقُ مع الناس، وأن يحمل من الدين ما يُقيم به نفسه ويُحسن به إلى غيره، وأن يتعلم فقه الأولويات، وأن يدعو بالحكمة، وأن يَصْدُق مصداق قول الله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159]، مع تذكُّر قاعدة الإسلام العظمى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256].
وإذا تأملنا آثار الدعوة في حياة المسلم الجديد وجدناها أعظم معينٍ له على الثبات؛ فكما أن العلم يُثبّت، والصحبة تُعين، فكذلك الدعوة تُحيي القلب وتمنح الإيمان طراوةً متجددة، وإن أقوى دعامةٍ تُثبِّت المسلم الجديد على طريقه أن يُشرك قلبَه ووقته في هَمِّ البلاغ؛ فالدعوة ليست عبئًا إضافيًا فوق الدين، بل هي روح الدين وقد صحّ في الحديث قوله ﷺ لعليّ رضي الله عنه يوم خيبر: “فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك من حُمْر النَّعَم”. وفي الحديث أيضًا: “من دلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجرِ فاعله”. هذان الأصلان يُنشئان حافزًا داخليًا قويًا للمسلم الجديد؛ إذ يشعر أن الله قد استخدمه في مشروعٍ هداية مباركٍ ممتد يواصل به مسيرة الأنبياء، وأن حياته قبل الإسلام –بخبراتها وعلاقاتها– لم تذهب سدى، بل تحوَّلت إلى جسور نحو الحق.
ولهذا كان من أهم الواجبات على الأمة أن تُحسن استقبال هؤلاء المهتدين الجدد إلى رحاب الإسلام، وألا تتركهم فريسة للوحدة أو العزلة أو الضعف، بل تُمدهم بالعلم الصحيح، وتُحيطهم برعاية روحية واجتماعية تُثبِّتهم على الطريق، وتُهيئهم للقيام برسالتهم الدعوية. إذ إن دوافع الشكر لله على النعمة تكون آنئذٍ في ذروتها. هنا يصبح “الاشتباك الإيجابي” مع مجتمعه هو طريق التثبيت؛ فبقدر ما يعطي بقدر ما يثبت، وبقدر ما يخدم بقدر ما ينمو إيمانه.
ولنا أن نُذكّره دائمًا بكلام النبوّة الجامع: “خيرُكم من تعلَّم القرآنَ وعَلَّمه”. وقال النبي ﷺ: “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا”، وقال أيضًا: “مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.
كيف نُفعِّل المسلم الجديد في مجتمعه؟
سؤال عمليٌّ بامتياز، وإجابته تحتاج إلى خطة متعددة المستويات: فردية وأُسرية ومؤسسية وإعلامية.
خطةٌ شخصية واضحة: نضع مع المسلم الجديد برنامجًا يسيرًا لثلاثة أشهر ثم ستة ثم سنة، يشتمل على:
أولاً: ورد يومي من القرآن مع فهم معاني الفاتحة وقصار السور.
ثانياً: حضور درسٍ أسبوعي في العقيدة والعبادات.
ثالثاً: صحبةٌ مُنتقاة لرفاقٍ يُعينونه على الصلاة والذكر.
رابعاً: مشاركةٌ شهرية في عملٍ خيري أو دعوي بسيط.
هذا البناء المتدرّج يحوّل الإسلام إلى عادةٍ يومية لا إلى انفعالٍ موسمي.
اللغة جسرٌ لا حاجز: كثيرٌ من المسلمين الجدد يحتاجون دعمًا لغويًا: ترجماتٍ أمينة، ومعجمًا مبسّطًا للمصطلحات، ودوراتٍ قصيرة في تلاوة الفاتحة والأذكار. توفير تطبيقات ومذكّرات صوتية بلغتهم الأم يُضاعف ارتباطهم بالقرآن.
الرفيقُ المربّي: تُعيِّن كلُّ مؤسسةٍ أو مشروع دعوي أو مسجد “رفيقًا” للمسلم الجديد؛ يزورُه، يُصادقه، يجيب على أسئلته، ويُرافقه إلى المسجد ومجالس العلم، ويعرّفه بالمجتمع المسلم. هذا الرفيق ليس “مراقبًا” ولا “محققًا”، بل أخاً رحيماً يسمع أكثر مما يتكلم، ويُعلّم بالقدوة قبل العبارة.
التخصّصُ في الدعوة: ليس كلُّ مسلمٍ جديدٍ سيُجيد المنبر أو المناظرة؛ منا من يبرع في الكتابة، ومن يُحسن إدارة النوادي والجمعيات، ومن يُتقن الإعلام الرقمي، ومن يلمع في خدمة الفقراء، ومن يبدع في التربية الرياضية أو الفنية بضوابطها. المطلوب أن نكتشف “موهبته الطبيعية” ونُطعّمها بنور الإيمان. الدعوة عندئذٍ تصبح امتدادًا لمهاراته لا قيدًا عليها.
القصصُ يجذب القلوب: لِيَحكِ المسلمُ الجديد قصته ورحلته إلى الإسلام بصدقٍ دون تهويل ولا تجريح لأحد؛ قصةُ انتقاله من الحيرة إلى اليقين، من الضيق إلى السعة. القصة الصادقة أكبر تأثيرًا من ألفِ خطابٍ جاف. لكن ننبّه: ليس كلُّ أحدٍ مؤهّلًا للتصدّر الإعلامي؛ نحفظ للناس خصوصياتهم، ونوازن بين الفائدة والمفسدة.
العملُ الخيري بوابةٌ واسعة: المشاركة المنتظمة -ولو لساعات- في أعمال خيرية، أو دروس تقوية للطلاب.. إلخ، تُعرّف المجتمع على جمال الإسلام العملي، وتمنح المسلم الجديد شبكة علاقاتٍ حقيقية يتنفس فيها الأخوّة.
المسجد بيتٌ لا صالةُ مرور: تدريب القائمين على المساجد على آداب الاستقبال، توفير “ركنٍ تعريفي” بلغات متعددة، وضع جدول لقاءاتٍ أسبوعي للمسلمين الجدد مع إمامٍ مُحسنٍ ولجنةٍ من الإخوة والأخوات تُعنى بالجانب الاجتماعي والأسري، مع غرفةٍ صديقة للأطفال؛ كل ذلك يحوّل المسجد إلى حضنٍ تربوي.
التعاملُ مع الأسرة القديمة: نُعلّم المسلم الجديد فقهَ البرّ بأهله ولو كانوا غير مسلمين، وأن يختار أساليبه بحكمةٍ ولطفٍ دون صدامٍ، ويُظهر لذويه صدق المعاملة وطيب الأخلاق.
حصانةٌ فكريةٌ رقميّة: نُعرّفه على مصادر العلم الموثوقة، ونحذّره من فوضى المنصات، ونُدربه على التثبت من الأخبار والفتاوى، وأن يسألَ أهل الذكر: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
مكاسب صغيرةٌ متراكمة: نُشعره بالإنجاز خطوةً خطوة: تعلّم الفاتحة وقصار السور، الحفاظ على الصلوات الخمس، صدقة خفية، إصلاح علاقة، دعوة صديقٍ واحد. هذه الانتصارات الصغيرة تُراكم الثقة وتُذيب الوحشة.
ما الواجب علينا –نحن المسلمين– تجاه المهتدين الجدد؟
أولًا: التهنئة الصادقة والاستقبال اللائق؛ استقبالٌ يليق بعظيم النعمة، بلا مبالغةٍ مسرحية ولا برود. نُعرّفه بأننا أسرته الجديدة، وأننا له عونٌ في العلم والرزق والعلاقات.
ثانيًا: التكفّل العلمي المنهجي؛ إعداد مسارٍ تعليميّ منضبط، يبدأ بالفَرْض العين والعقيدة، ثم أصول المعاملات، مع كتبٍ مختصرةٍ موثوقة، وحلقاتٍ منتظمة، واختبارٍ دوري لطيف.
ثالثًا: التكافل الاجتماعي؛ بعض المسلمين الجدد يفقد دعم أسرته أو عمله، أو يواجه ضغوطًا قانونية ونفسية. هنا يجيء قول النبي ﷺ: “المسلمُ أخو المسلم، لا يظلمه ولا يَسلِمه… ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته….”.
رابعًا: الإدماج في الجماعة؛ لا نُبقِ المسلم الجديد “ضيفًا أبديًا” على هوامش المجتمع. نُسند إليه أدوارًا حقيقية: تنظيم، ترجمة، تعليم مبتدئين، إدارة نشاطٍ خيري، الإسهام في محتوى رقمي. التكليف المدروس يسبق التصدّر، ويمنعه في الوقت نفسه من الانعزال والذوبان.
خامسًا: حراسة القلوب من الإفراط والتفريط؛ نحميه من الغلو الذي يُشوّه الدين، ومن التفلت الذي يُضيّع معالمه. نُعلّمه أن العبودية ميزان: محكماتٌ قبل الجزئيات، ثوابت قبل المتغيرات، حقٌّ قبل أشخاص.
سادسًا: فقهُ الخلاف والرحمة بالخلق؛ لا نُدخل المسلم الجديد في معاركنا الجانبية، ولا نُعلّمه ازدراء الناس. نُربيه على أن الدعوة نفاذٌ إلى القلوب لا كسرٌ للناس.
سابعًا: الأمان النفسي للأسئلة؛ كثير من المهتدين الجدد يحملون أسئلةً حسّاسة عن قضايا المرأة، الحرية، القَدَر، العلاقة بالآخر.. يجب أن نوفر لهم “مساحةَ سؤالٍ آمنة” بلا تخويف، وأن نُحسن الإجابة بعلمٍ ورفق.
ثامنًا: الدعاء سلاحُ المؤمن؛ نذكّره ونذكّر أنفسنا أن الهداية من الله وحده، وأن التثبيت عطية ربانية: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ [إبراهيم: 27]. أن الدعاء سهم لا يخيب في جعبة المسلم الحق.
استراتيجية صناعة السفراء!
إن تهيئة المسلم الجديد كي يصبح سفيراً للإسلام في بيئته ومجتمعه تتطلب مناخًا من الحكمة والرحمة والعدل. السفير الحقّ ليس من يحفظ عباراتٍ بل من يَصدُقُ في أخلاقه، وتظهر في سلوكه آثارُ الإسلام. كيف نُدرِّبه على ذلك؟
ميثاق الهوية اليومية: صلاةٌ في وقتها، وردُ دائم من القرآن ولو قليل، صدقةٌ أسبوعية، خُلُقٌ مُلزِم: الصدق. هذه الأربع عُمُدٌ لا يُساوم عليها.
خريطةُ العلاقات: يُحافظ على جسورٍ حسنةٍ مع أهله غير المسلمين ما لم تمسّ دينه، ويتخير من المسلمين أصحابَ الهمم والقلوب الرحيمة.
البلاغ العملي: أن يدعو بالعمل قبل القول: إتقانُ عمله، أمانته في وظيفته، لطفُه في الجوار، رِفقُه بالحيوان والبيئة. هذا بلاغٌ صامت يَسبق المقال.
البلاغ القولي المُبسّط: يحفظ المسلم الجديد عشرات الأجوبة القصيرة على الأسئلة الشائعة حول الإسلام، مع مراجع موثوقة بلغته، دون خوضٍ في ما لا يُحسن.
مشاريع صغيرة متدرجة: نادي قراءةٍ لكتابٍ تعريفي، حلقةُ قرآنٍ للمبتدئين، لقاءٌ دوري لشرب القهوة والحوار، منصةٌ صغيرة على الشبكات ينشر فيها خواطره بإذن مشرفٍ تربويّ.
التعلّم المستمر: يُجدّد نيته دائمًا، ويستحضر الحديث: “إنما الأعمال بالنيات”. ولا ينسى قاعدة: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمُت”. فالسكوت عن ما لا يعلم عبادة.
ميزانُ الحكمة: كلما احتار قالبُ الدعوة، رجع إلى أصلين: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾ [النحل: 125]، و”يسِّروا ولا تعسِّروا…”.
وعلى مستوى الأمة:
نحتاج إلى خارطة طريقٍ مؤسسية تُحوِّل الآمال والنوايا الحسنة إلى صناعةٍ مستدامة من خلال:
مراكزُ تعريفٍ بالإسلام متعددة اللغات، قوتها في جودة المحتوى ودفء الاستقبال.
برامج كفالة تعليمية للمسلمين الجدد: منحة كتاب، دورة فقه أساسي، مصحفٌ مُترجم، استشارات أسرية ونفسية…وأخرى.
شبكاتُ صداقةٍ عالمية تربط المسلمين الجدد بعضهم ببعض، يتبادلون الخبرة والتشجيع.
منصاتٌ رقمية تقدم محتوى موثوقًا: دروسًا قصيرة، أسئلةً وأجوبة، قصصَ هدايةٍ رصينة، ومساحاتِ نقاشٍ تحت إشرافٍ علمي.
أدلةٌ عملية للمساجد: كيف نستقبل الداخلين الجدد؟ ما المواد الأولى التي نعطيهم؟ كيف نُتابعهم بعد أسبوعٍ وشهرٍ وسنة؟
إشراكُ المرأة المسلمة الجديدة في برامج خاصّة تحفظ خصوصيتها وتُطلق طاقتها؛ فهي سفيرةٌ في بيتها ومحيطها وفضائها المهني.
تقييمٌ دوري بمعايير واضحة: (الاستمرار في العبادة، جودة الفهم، دائرة التأثير، درجة الاندماج، الاستقرار النفسي والاقتصادي).
وفي خاتمة المطاف
تبقى الصحبة الصالحة والذكر والدعاء هي الأعمدة التي لا غناء عنها؛ فالهداية والتثبيت بيد الله وحده. نحن نأخذ بالأسباب ونُحسن السعى ونُجوّد العمل،﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾[ يوسف: 108]، وقلوبنا معلّقة بقوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8]. وليكن شعارنا في التعامل مع المسلم الجديد: رفقٌ يفتح القلوب، وعلمٌ يُضيء العقول، وعملٌ يترجم الإيمان في الأسواق والبيوت والطرقات.
إن المسلم الجديد ليس صفحةً تُطوى بعد الشهادة، بل قصة رسالة تبدأ من يوم النطق وتستمر إلى لقاء الله. وإذا أحسنَّا رعايته وتفعيله، صار –بإذن الله– لسان صدقٍ في قومه، يَهدي ويُبين، ويشهدُ على الناس أن هذا الدين رحمةٌ وعدلٌ ونور. وإن قصّرنا في حقّه، فقد خذلنا أنفسَنا وديننا قبل أن نخذله.
فلنجدّد العهد مع قول الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [سورة العصر]؛ فـ”التواصي بالحق والصبر” هو عنوان هذه الرسالة. ولنستمسك بوعد النبي ﷺ: “من دلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجرِ فاعله”. وعندها فقط تتحوّل عبارة “المسلمون الجدد مشاريع سفراء للإسلام” من شعارٍ برّاق وهدف مأمول إلى واقعٍ ملموس؛ رجالًا ونساءً يحملون نور الإسلام بأخلاقهم قبل أقوالهم، ويُقيمون الحجة للعالمين بأن المستقبل لهذا الدين الذي يُصلح الدنيا والآخرة.
والحمد لله رب العالمين.




