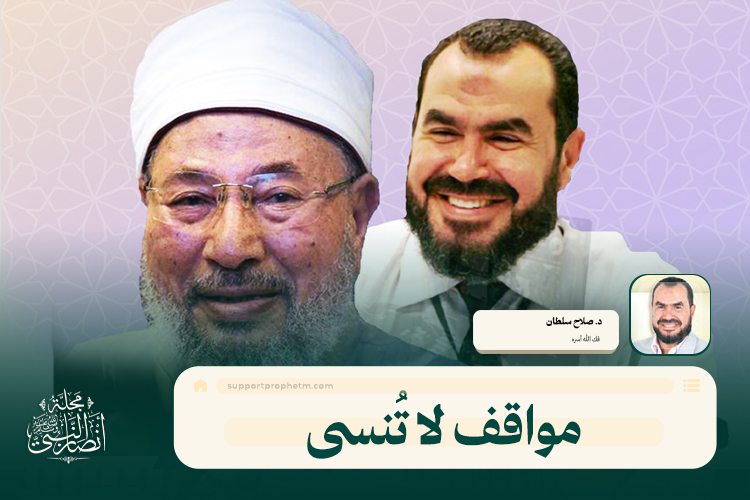الصحابة معجزة بحق (1/2)
أكتوبر 8, 2024
في ذكرى المولد النبوي
أكتوبر 8, 2024أحمد بن مصطفى المراغي – رحمه الله –
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ * وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّمَاۤ أَمۡوَ الُكُمۡ وَأَوۡلَـٰدُكُمۡ فِتۡنَةࣱ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥۤ أَجۡرٌ عَظِیمࣱ﴾ [الأنفال: 27-28].
الخيانة: لغة تدل على الإخلاف والخيبة بنقص ما كان يُرجَى ويؤمَّل من الخائن، فقد قالوا: “خانه سيفه” إذا نبا عن الضّربية، و”خانته رجلاه” إذا لم يقدر على المشي، ومنه قوله: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: تنقصونها بعض ما أحلّ لها من اللذات، ثم استُعمل في ضد الأمانة والوفاء؛ لأن الرجل إذا خان الرجل فقد أدخل عليه النقصان.
والأمانة: كل حق مادّي أو معنوي يجب عليك أداؤه إلى أهله؛ قال تعالى: ﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضࣰا فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
والفتنة: الاختبار والامتحان بما يشقّ على النفس فعله أو تركه أو قبوله أو إنكاره، فهي تكون في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأشياء، فيمتحن اللّه المؤمنين والكافرين والصادقين والمنافقين، ويجازيهم بما يترتب على فتنتهم من اتباع الحق والباطل وعمل الخير أو الشر.
رُوي أن أبا سفيان خرج من مكة (وكان لا يخرج إلا في عداوة الرسول ﷺ والمؤمنين) فأعلم اللّه رسوله بمكانه، فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: “إن محمداً يريدكم فخذوا حذركم”؛ فأنزل اللّه ﴿لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ الآية.
ورُوي أنها نزلت في أبي لبابة وكان حليفاً لبني قريظة من اليهود، فلما خرج إليهم النبي ﷺ بعد إجلاء إخوانهم من بني النّضير، أرادوا بعد طول الحصار أن ينزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ، وكان من حلفائهم من قبل غدرهم ونقضهم لعهد النبي ﷺ، فأشار إليهم أبو لبابة ألا تفعلوا وأشار إلى حلقه (يريد أن سعداً سيحكم بذبحهم) فنزلت الآية.
قال أبو لبابة: ما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني خنت اللّه ورسوله، روى أن رسول اللّه ﷺ سأل امرأته: أيصوم ويصلي ويغتسل من الجنابة؟ فقالت: “إنه ليصوم ويصلي ويغتسل من الجنابة ويحب اللّه ورسوله”.
وقد رُوي أن أبا لبابة شدّ نفسه على سارية من المسجد وقال: “واللّه لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب اللّه عليّ”، ثم مكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خر مغشياً عليه، ثم تاب اللّه عليه، فقيل له: قد تيب عليك، فقال: “واللّه لا أحلّ نفسي حتى يكون رسول اللّه ﷺ هو الذي يحلّني” فجاء ﷺ فحلّه بيده.
- ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾
أي: لا تخونوا اللّه فتعطّلوا فرائضه أو تتعدوا حدوده وتنتهكوا محارمه التي بيّنها لكم في كتابه، ولا تخونوا الرسول ﷺ فترغبوا عن بيانه لكتابه، إلى بيانه بأهوائكم أو آراء مشايخكم أو آبائكم أو أوامر أمرائكم، أو ترك سُنته إلى سُنة آبائكم وزعمائكم زعماً منكم أنهم أعلم بمراد اللّه ورسوله منكم.
- ﴿وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ﴾
أي: ولا تخونوا أماناتكم فيما بين بعضكم وبعض من المعاملات المالية وغيرها، حتى الشئون الأدبية والاجتماعية، فإفشاء السر خيانة محرمة، ويكفي في العلم بكونه سراً قرينة قولية؛ كقول محدثك: هل يسمعنا أحد؟ أو فعلية كالالتفات لرؤية من عساه يجىء، وآكد أمانات السر وأحقها بالحفظ ما يكون بين الزوجين.
كذلك لا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وبين أولي الأمر؛ من شئون سياسية أو حربية، فتُطلِعوا عليها عدوكم وينتفع بها في الكيد لكم.
والخيانة من صفات المنافقين، والأمانة من صفات المؤمنين، قال أنس بن مالك: قلّما خطب رسول اللّه ﷺ إلا قال: “لا إيمان لمن لا عهد له”1.
روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: “آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم”.
- ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
أي: وأنتم تعلمون مفاسد الخيانة وتحريم اللّه لها وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، وقد يكون المعنى: وأنتم تعلمون أن ما فعلتموه خيانة لظهوره، فإن خفى عليكم حكمه فالجهل له عذر إذا لم يكن مما عُلم من الدين ضرورةً، أو مما يُعلم ببداهة العقل، أو باستفتاء القلب؛ كفعلة أبي لبابة التي كان سببها الحرص على المال والولد، ومن ثَم فطِن لها قبل أن يبرح مكانه.
- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾
أي: إن فتنة الأموال والأولاد عظيمة لا تخفى على ذوي الألباب، إذ أموال الإنسان عليها مدار معيشته وتحصيل رغائبه وشهواته ودفع كثير من المكاره عنه، من أجل ذلك يتكلف في كسبها المشاق ويركب الصعاب، ويكلفه الشرع فيها التزام الحلال واجتناب الحرام، ويرغّبه في القصد والاعتدال، ويتكلف العناء في حفظها وتتنازعه الأهواء في إنفاقها، ويفرض عليه الشارع فيها حقوقاً معينة وغير معينة؛ كالزكاة ونفقات الأولاد والأزواج وغيرهم.
وأما الأولاد فحبهم مما أُودع في الفطرة، فهم ثمرات الأفئدة وأفلاذ الأكباد لدى الآباء والأمهات، ومن ثَم يحملهما ذلك على بذل كل ما يُستطاع بذله في سبيلهم؛ من مال وصحة وراحة. وقد رُوي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى النبي ﷺ: “الولد ثمرة القلب، وإنه مجبنة مبخلة محزنة”.
فحب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف الذنوب والآثام في سبيل تربيتهم والإنفاق عليهم وتأثيل الثروة لهم، وكل ذلك قد يؤدي إلى الـجُبن عند الحاجة إلى الدفاع عن الحق أو الأمة أو الدين، وإلى البخل بالزكاة والنفقات المفروضة والحقوق الثابتة، كما يحملهم ذلك على الحزن على مَن يموت منهم بالسخط على المولى والاعتراض عليه. إلى نحو ذلك من المعاصي كنوح الأمهات وتمزيق ثيابهن ولطم وجوههن. وعلى الجملة ففتنة الأولاد أكثر من فتنة الأموال، فالرجل يكسب المال الحرام ويأكل أموال الناس بالباطل لأجل الأولاد!
فيجب على المؤمن أن يتقي الفتنتين، فيتقي الأولى بكسب المال من الحلال وإنفاقه في سبيل البر والإحسان، ويتقي خطر الثانية من ناحية ما يتعلق منها بالمال ونحوه بما يشير إليه الحديث، ومن ناحية ما أوجبه الدين من حسن تربية الأولاد وتعويدهم الدين والفضائل وتجنيبهم المعاصي والرذائل.
- ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾
فعليكم أن تؤثروا ما عند ربكم من الأجر العظيم بمراعاة أحكام دينه في الأموال والأولاد على ما عساه قد يفوتكم في الدنيا من التمتع بهما.
- ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾
التقوى: ترك الذنوب والآثام، وفعل ما يستطاع من الطاعات والواجبات الدينية، وبعبارة أخرى: هي اتقاء ما يضر الإنسان في نفسه وفي جنسه، وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة والغايات الحسنة، والفرقان: أصله الفرق والفصل بين الشيئين أو الأشياء، ويُراد به هنا نور البصيرة الذي به يفرّق بين الحق والباطل والضّارّ والنافع، وبعبارة ثانية: هو العلم الصحيح والحكم الرجيح.
وقد أُطلق هذا اللفظ على التوراة والإنجيل والقرآن، وغلب على الأخير، قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِی نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِیَكُونَ لِلۡعَـٰلَمِینَ نَذِیرًا﴾ [الفرقان: ١]. من قِبل أن كلامه تعالى يفرق في العلم والاعتقاد بين الإيمان والكفر، والحق والباطل، والعدل والجور، والخير والشر.
لـمّا حذّر اللّه تعالى من الفتنة بالأموال والأولاد، قفى على ذلك بطلب التقوى التي ثمرتها ترك الميل والهوى في محبة الأموال والأولاد.
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً﴾ أي: إن تتقوا اللّه فتتبعوا أوامر دينه وتسيروا بمقتضى سُننه في نظام خلقه.. يجعل لكم في نفوسكم ملَكة من العلم تفرّقون بها بين الحق والباطل، وتصلون بين الضار والنافع، وهذا النور في العلم الذي لا يصل إليه طالبه إلا بالتقوى هو الحكمة، التي قال اللّه تعالى فيها: ﴿وَمَن یُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِیَ خَیۡرࣰا كَثِیرࣰاۗ وَمَا یَذَّكَّرُ إِلَّاۤ أُو۟لُوا۟ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].
واتقاء اللّه يتحقق بمعرفة سُننه في الإنسان وحده أو فيه وهو في المجتمع الإنساني، كما ترشد إلى ذلك آيات الكتاب الحكيم في مواضع متفرقة منه، ومن ثم كانت ثمرة التقوى حصول ملكة الفرقان التي بها يفرّق صاحبها بين الأشياء التي تعرض له من علم وحكمة وعمل، فيفصل فيها بين ما ينبغي فعله وما يجب تركه.
وعلى الجملة فالمتقي للّه يؤتيه اللّه فرقاناً يميز به بين الرشد والغي، ومن ثم كان الخلفاء والحكام من الصحابة والتابعين من أعدل حكام الأمم في الأرض، حتى لقد قال بعض المؤرخين من الإفرنج: “ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب”.
﴿وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي: ويمح بسبب ذلك الفرقان وتأثيره ما كان من دنس الآثام في النفوس، فتزول منها داعية العودة إليها، ويغطيها فيسترها عليكم فلا يؤاخذكم بها، واللّه الذي يفعل ذلك بكم له الفضل العظيم عليكم وعلى غيركم من خلقه.
وفي قوله ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ إيماء وتنبيه إلى أن ما وعد به المتقين من المثوبة فضل منه وإحسان تفضل به علينا، دون واسطة ودون التماس عِوض.
ـــــــــــــــــــــــــ
* مفسر أصولي مصري معروف، وهو شقيق شيخ الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغي، وأشهر مؤلفاته هذا التفسير المعروف بتفسير المراغي الذي نقلنا منه هذا المقال، وذلك من موضع سورة الأنفال في الآية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين منها.
1 رواه الإمام أحمد.