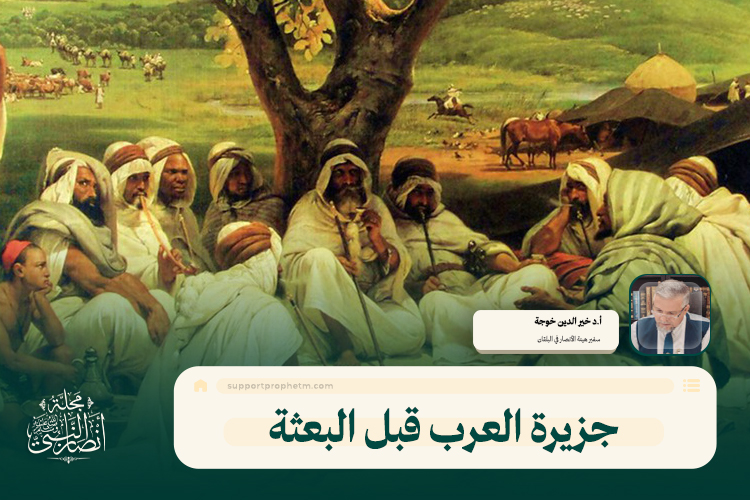الاحتلال يوسع اقتحاماته في الضفة وأريحا
يوليو 11, 2025
استشهاد مرابطيْن من أهل الضفة و40 إصابة في عدوان المستوطنين
يوليو 12, 2025جزيرة العرب قبل البعثة
أ.د خير الدين خوجة الكوسوفي
سفير الهيئة العالمية لأنصار النبي ﷺ في البلقان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فهذه حلقة خامسة في تناول مباحث السيرة النبوية نحاول من خلالها العرض والتحليل بمنهجية حركية قابلة للاستيعاب والتطبيق. لوحظ مؤخراً في كثير من الكليات الإسلامية في العالم أن هذا المنهج الحركي العملي لمضامين السيرة النبوية شبه غائب، فما دام الأمر كذلك فما على خادمي السنة النبوية وأنصارها إلا أن يعيدوا هذه الروح المفقودة إلى موضوعات ومباحث السيرة النبوية لكي تعطي أُكلها بإذن ربها.
ومن جملة المباحث المتعلقة بدراسة السيرة النبوية: معرفة أصول العرب والقبائل العربية والديانات الموجودة لديهم قبل البعثة المحمدية، لأن النبي ﷺ عربي قح من أبوين عربيين؛ فوجب علينا بيان هذه الحقيقة التاريخية حتى يزداد حب الدارسين والمدرسين لهذا النبي الأمي العربي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إن الحديث عن أصل العرب وقبائلهم وفروعهم من خلال الفقرات التالية:
أولاً: طبقات العرب
اتفق الرواة وأهل الأخبار على تقسيم العرب من حيث التقدم إلى ثلاثة أقسام:
1- عرب بائدة.
2- عرب عاربة.
3- عرب مستعربة أو المتعربة.
واتفقوا أيضاً على تقسيم العرب من حيث النسب إلى قسمين:
1- قحطانية، منازلهم الأولى في اليمن.
2- وعدنانية، منازلهم الأولى في الحجاز.
ويرى البعض أن القحطانية هم الأصل والعدنانية هم الفرع، ويرى بعض المحققين من المعاصرين أن العدنانيين هم الأصل. وتذكر الروايات أنه كان بين القحطانية والعدنانية عداء شديد ظل قروناً طويلة. وتذكر الروايات أن إسماعيل عليه السلام هو الجد الأكبر للعرب المستعربة أو المتعربة، وسُمُّوا بذلك لأن إسماعيل عليه السلام كان يتكلم السريانية أو العربية، فلما نزلت قبيلة جُرْهُم –من القحطانيين- إلى مكة سكنوا معه ومع أمه وتزوج منهم وتعلم هو وأبناؤه العربية، فسموا (العرب المستعربة)، ولكن هذا لا يصح، لأن عصر إبراهيم عليه السلام وابنه هو عصر عربي قائم بذاته، فإبراهيم وابنه إسماعيل ينتميان إلى القبائل الآرامية العربية القديمة، ليست له صلة بعصر اليهود، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: 67].
لأن إبراهيم عليه السلام ولد بجنوبي العراق واستقر في مدينة أور الكلدانية، وقرية كوثي هي قرية بالكوفة وفيها كانت محاولة الإحراق لإبراهيم عليه السلام، ثم سار إلى حران شمال الجزيرة، ثم إلى فلسطين ومعه زوجه سارة وابن أخيه لوط عليه السلام، ومن ثم انتقل مع ابن أخيه لوط إلى مصر. ثم عاد مع لوط إلى جنوب فلسطين، ثم افترقا ليجد كل منهما سقاية وكلأ لماشيته، فسكن لوط في جنوب البحر الميت في بحيرة لوط، وسار إبراهيم مع زوجته الثانية (هاجر) إلى مكة المكرمة ومعه ابنه إسماعيل عليه السلام، وتركهما في وادٍ غير ذي زرع وتفجر ماء زمزم، ثم جاءت جُرهم عن طريق (كداء). مات إبراهيم عليه السلام ودفن في مدينة الخليل (حبرون) في فلسطين.
ثانياً: وحدة اللغة
امتازت الجزيرة العربية على سَعَتها وامتدادها وتشتت قبائلها بوحدة اللغة بين أبناء الجزيرة العربية، حَضَرِهم وبدوهم والقحطاني منهم والعدناني، على اختلاف لهجاتها وفروقها الإقليمية. فاللغات تختلف في لهجاتها بمسافات طويلة أو قصيرة، وهذه الوحدة في اللغة يسرت الدعوة الإسلامية وسرعة انتشار الإسلام فيها.
ثالثاً: صلة الجزيرة العربية بالأديان السابقة
والجزيرة العربية كانت مهد نبوات كثيرة ومبعث عدد من الأنبياء، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأحقاف: 21]، وقبيلة عادٍ من العرب الجبارين والعرب البائدة، على قول بعض المؤرخين، وكان موطنها الأحقاف، والحقف: كثيب مرتفع من الرمال، وكانت منازلهم في جنوب الجزيرة، في جنوب الربع الخالي، قريباً من حضرموت، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، جلبت عليهم طوفاناً من الرمال.
وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ دليل على أن هوداً عليه السلام الذي أُرسل إلى عاد قد سبقه ولحقه أنبياء.
وكذلك نبي الله صالح عليه السلام أُرسل إلى ثمود، وثمود كانت تسكن جزيرة العرب في الـحِجر، (مدائن صالح– مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية وكانت لي زيارة شخصية مع أسرتي أيام عملي في جامعة طيبة بالمدينة المنورة في 2004- 2009)، الذي بين الحجاز وتبوك، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ * وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً آمِنِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾ [الحجر: 80-83].
رابعاً: علاقة دعوة محمد ﷺ بالدعوات السماوية السابقة
يقول سيدنا ونبينا محمد ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: “مَثَلي ومَثَلُ الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لَبِنَة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين”.
فدعوته قائمة على أساس التأكيد والتتميم، كما يدل الحديث المذكور.
وبيان ذلك أن دعوة كل نبي تقوم على أساسين اثنين:
1- العقيدة.
2- التشريع والأخلاق.
أما العقيدة فلم يختلف مضمونها منذ خلْق آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين ﷺ. وكان كل نبي يأتي مصدقاً لدعوة مَن قبله من الرسل، هكذا تلاحقت بعثتهم إلى مختلف الأقوام لتحقيق العبودية والدينونة لله عز وجل. وقد بيّن الله عز وجل هذا في القرآن الكريم: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: 13].
ومن غير المعقول أن تختلف دعوات الأنبياء في العقيدة، لأن أمور العقيدة من نوع الإخبار عن الله عز وجل فيما يتعلق بالله بذاته وصفاته وأسمائه والغيبيات الأخرى، فلا يمكن أن تختلف الأخبار من واحد إلى آخر، ولا يمكن أن يقول نبي إن الله ثالث ثلاثة! سبحانه عما يقولون، ثم يبعث نبي من بعد يقول إن الله واحد لا شريك له!
أما التشريعات والأحكام فكانت تختلف في الكيف والكم من نبي لآخر ومن قوم لآخر ومن مكان لآخر، لأن التشريع من الإنشاء والتأسيس والتنظيم لأمور العباد والبلاد وليس من نوع الإخبار، ومن الطبيعي أن يكون للتطور الزمني أثر في تطور التشريع واختلافه، لأن فكرة التشريع قائمة على أساس مصالح العباد، وأن بعثة كل نبي كانت خاصة بأمة معينة ولم تكن عامة لجميع الناس، فكانت الأحكام التشريعية محصورة في إطار ضيق حسبما تقتضيه مصالح تلك الأمة.
مثال على ذلك: شريعة موسى عليه السلام..
قد كانت قائمة على أساس العزائم لا الرخص، شريعة شديدة على بني إسرائيل فيها أغلال بسبب طبيعة بني إسرائيل الخائنة والمميعة.
وجاء عيسى عليه السلام بعده بشريعة أسهل وأيسر فيسّر عليهم كثيراً من الأمور وأحلّ لهم كثيراً من الأشياء التي كانت قد حُرمت عليهم بسبب ظلمهم وفسقهم وخبثهم. قال تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ﴾ [آل عمران: 3]. وقال تعالى: ﴿وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ [آل عمران: 50].
وبناء على هذا فإن بعثة كل رسول تتضمن عقيدة وتشريعاً، فالعقيدة تأكيد للعقيدة التي بُعث بها الرسل، وأما التشريع، فإن شريعة كل رسول ناسخة للشريعة التي قبلها، إلا ما أيّده التشريع المتأخر، أو سكت عنه، ويظهر هذا واضحاً في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون ﴾ [المائدة: 48].
ومعنى قوله تعالى: “مهيمناً عليه” أي: حاكماً ومسيطراً وموجهاً ومصححاً لما قبلها من الكتب التي حرفها أتباعها، كما قال بذلك كثير من المفسرين مثل الإمام ابن كثير وغيره رحمهم الله.
فمع نزول القرآن الكريم بطل الإيمان وتم إلغاء العمل بالكتب السابقة، فوجب على اليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الأديان الوضعية قبول القرآن الكريم وبما جاء به، ولا يكون ذلك إلا بالدخول في الإسلام والاستسلام الكامل والمطلق لله رب العالمين.
ومن هذا العرض يتضح أن ما نسمعه كثيراً وما نراه في كتابات بعض الباحثين والعلماء بـ(الأديان السماوية) ليس هناك شيء اسمه أديان سماوية متعددة، وإنما هناك دين واحد وهو الإسلام وأن هناك شرائع سماوية متعددة كما ذكرنا، نَسَخ وأَلغى اللاحق منها السابق، إلى أن استقرت الشريعة الأخيرة التي قضت حكمة الله أن يبلّغها خاتم الرسل والأنبياء، وأما الدين الحق فواحد لا ثاني له، ألا وهو الإسلام، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران:19].
بهذا الدين بُعث إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥۤ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ * وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 130-132].
وبه بُعث موسى إلى بني إسرائيل، قال تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقلِبُونَ * وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِين﴾ [الأعراف: 125-126].
وبه بُعث عيسى عليه السلام، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 52].
فالأنبياء كلهم بُعثوا بالإسلام الذي هو الدين الخاتم الصحيح والمقبول عند الله وما سوى ذلك فلا، وأهل الكتب من اليهود والنصارى يعلمون وحدة الدين ويعلمون أن الأنبياء إنما جاؤوا ليصدق بعضهم بعضاً، ولكنهم اختلقوا على أنبيائهم ما لم يقولوه.
خامساً: الجاهلية وما كان فيها من بقايا الحنيفية
هذه مقدمة هامة لا بد من دراستها قبل الخوض في مباحث السيرة النبوية. وخلاصة القول فيها إن الإسلام ما كان إلا امتداداً للحنيفية السمحة التي بُعث الله بها إبراهيم عليه السلام، وقد صرح الله عز وجل بذلك في القرآن الكريم قائلاً: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: 78].
فلما امتدّ بهم الزمان والقرون أخذوا يخلطون الحق بالباطل، فدخل فيهم الشرك واعتادوا عبادة الأصنام وتسرّبت إليهم العادات والتقاليد الفاحشة فابتعدوا عن التوحيد وعن منهج الحنيفية السمحة، وعمت بينهم الجاهلية.
وكان أول من أدخل فيهم الشرك وعبادة الأصنام عمرو بن لُحيّ بن قمعة جد خزاعة.. فهو أول من غيّر دين إسماعيل عليه السلام؛ فنصَب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، وقد قال الرسول ﷺ عنه في الحديث الصحيح: “رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار”. وقصته معروفة في كيفية إدخال عبادة الأصنام في أرض العرب، لما خرج في بعض أسفاره من مكة إلى الشام ففي الطريق رأى ناساً يعبدون الأصنام فقال: ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ فقالوا: أصنام نعبدها نستمطر فتمطر، نستنصر فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطونني صنماً فأسير به إلى أرض العرب؟ فأعطوه صنماً يقال له هُبَل، فقدِم مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.
غير أنه بقيت منهم بقية من الناس ظلت متمسكة بعقيدة التوحيد سائرة على نهج الحنيفية السمحة، تصدق بالبعث والنشور وتوقن بالله يثيب المطيع ويعاقب العاصي، واشتهر من هؤلاء كثيرون، منهم: قس بن ساعدة الإيادي، ورئاب الشني، وبحيرا الراهب.
كما أنه بقيت في عاداتهم بقايا من عهد إبراهيم ومبادئ الدين الحنيف وشعائره، مشوهة فاسدة، وذلك كتعظيم البيت والطواف والحج والعمرة وكالوقوف بعرفة، فأصل هذا من عهد إبراهيم عليه السلام، ولكنهم كانوا يطبقونه على غير وجهه ويقحمون فيه الكثير ما ليس منه؛ مثل إهلالهم بالحج وفيها ألفاظ شركية، مثل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك!!