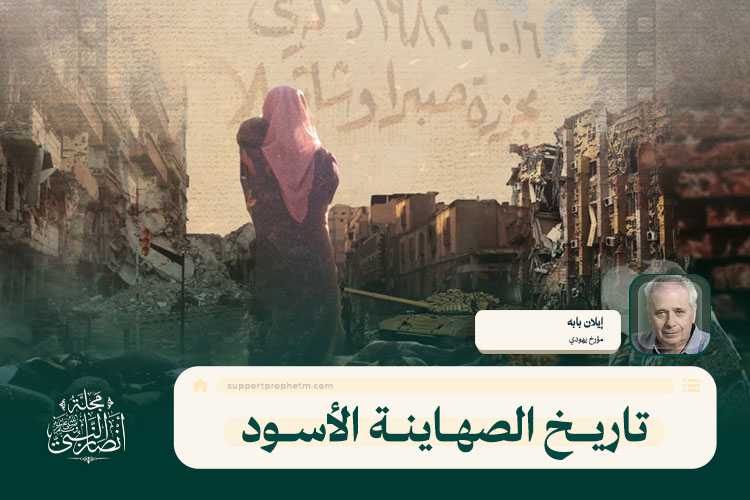الاحتلال يمنع إدخال مساعدات الشتاء لغزة
أكتوبر 26, 2025ديفيد هيرست
الصحافي البريطاني المعروف*
في المجتمع الديموقراطي عادة يكون الجديد أو غير المتوقع، وحتى المستفز أو الجدالي المتعمد، أو يجب أن يكون مرحباً به بوصفه جوهر الجدال والخلاف اللذين يتفرع عنهما فهم أكبر وتصحيح في نهاية المطاف للأرثوذكسية السائدة إن كانت خاطئة. لكن ذلك لا يصح ربما بالنسبة إلى الصراع العربي – الإسرائيلي بقدر ما يصح بالنسبة إلى أي موضوع آخر تقريباً، أو أن ذلك ينطبق على الأقل على أولئك –أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة- الذين يهيمنون على النقاش ويجعلون مهمتهم تشكيل الأرثوذكسية والحفاظ عليها.
في هذه الظروف، ربما كان من قبيل حسن الحظ أن (البندقية وغصن الزيتون) لاقى طريقه إلى النشر، بغض النظر عن مقدار الفشل الذي واجهه آنذاك. وفي زمن صدوره، كان المعلق اليهودي الشهير، أ. ف. ستون، يعبر عن حزنه للصعوبة الشديدة التي أصبحت تواجهها أي وجهة نظر بديلة حول الشرق الأوسط في الحصول على أي أذن صاغية. وقبل ثلاثين سنة كان ستون قد فاز بمكانة بطولية بين اليهود الأميركيين لتغطيته المباشرة لفرار اليهود الأوروبيين إلى فلسطين بعد الحرب، ونال عليها ميدالية من هاغاناه، الميليشيا الصهيونية السابقة لقيام الدولة.
لكنه اضطر في السبعينيات إلى أن يكتب ما يلي: “لا تلاقي حرية النقاش حول الشرق الأوسط تشجيعاً؛ لا نحظى نحن المنشقين إلا نادراً بصوت سريع الزوال في الصحافة الأميركية… إن إيجاد دار نشر أميركية مستعدة لنشر کتاب يبتعد عن الخط الإسرائيلي المعياري يوازي سهولة بيع شرح عميق للإلحاد للمرصد الروماني في مدينة الفاتيكان”.
ما من شك في أن الصهاينة تاريخياً لاقوا في كل مكان نجاحاً استثنائياً إلى حد كبير في الفوز بالتأييد الدولي لوجهة نظرهم وفي الحفاظ عليه، لكن ذلك لا يصح على أي مكان بقدر ما يصح على الولايات المتحدة حيث تمتعت إسرائيل كل الوقت بميل فريد إلى مصلحتها.
لقد نبع هذه العطف من خزان الموارد العاطفية والثقافية نفسها القائمة في أي مكان آخر في الغرب، والتي تتراوح بين الإيمان المسيحي -والفكرة العاطفية القائلة بأن عودة اليهود إلى أرض أسلافهم ستشكل تحقيقاً لنبوءة توراتية- وشعور الأغيار بالذنب لاضطهادهم اليهود عبر الأزمنة. لكنه كان هناك أقوى منه في أي مكان آخر، وكان المجتمع اليهودي الأميركي فاعلاً بشكل خاص في تحويله إلى دعم حكومي.
في كتابها (إدراك فلسطين)، تجادل كاثلين كريستيسون، المحللة السابقة في (سي. أي. آي)، أن “معظم الولايات المتحدة وقع في غرام إسرائيل”.
وقال آخرون إن “الأميركيين والإسرائيليين كانوا يرتبطون معاً ليس كمثل أي شعبين سيدين آخرين”، أو إن التماثل كان قريباً إلى درجة أن إسرائيل “شاركت في وجود المجتمع الأميركي”. كانت إسرائيل “واحدة منا”، موقعاً متقدماً للحضارة الغربية قلعة للديموقراطية، وحليفاً أساسياً في منطقة غريبة ومعادية ومضطربة غالباً.
وفيما اعتنقت الولايات المتحدة من دون تردد الرواية التاريخية الصهيونية، راحت ترى إسرائيل كما كانت إسرائيل ترى نفسها إلى هذا الحد أو ذاك. فولادتها كانت تعويضاً عن المحرقة، تلك الكارثة الكونية الكبرى، ونصراً للروح الإنسانية على عداء رهيب. وكانت “حرب الاستقلال” التي خاضتها، ذلك النضال الملحمي ضد عقبات هائلة شديدة الإيحاء بحيث إن نائب الرئيس آل غور تمكن بعد خمسين سنة من أن يقول، في سيل بلاغي لم يكن غير نمطي: “يشعر الأميركيون أن روابطنا بإسرائيل أبدية. لقد قام مؤسسونا، كمؤسسيكم برحلة في البرية بحثاً عن صهيون جديد. وكان نضالنا كنضالكم، إلهياً كما كان بشرياً. وقد أخبرنا أنبياؤنا، وأنبياؤكم، أن لديهم حلماً وقد جمعونا بحلمهم لخوض هذا النضال من أجل العدالة والسلام”.
لكن ما بدا للمعجبين الأميركيين سامياً وراقياً كان بالنسبة إلى الفلسطينيين نكبة. والواقع أنهم يطلقون على ذلك بكل بساطة كلمة “النكبة” منذ وقوعه. فالواقع أن الدولة اليهودية، بغض النظر عن كونها في حد ذاتها حلماً محترماً، كانت كذلك في أساسها وولادتها ونموها اللاحق مشروعاً استعمارياً. ربما كانت تختلف في نبضها الأول عن تلك الحركة العريضة من الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر الذي تفرعت عنه، لكنها في الوسيلة والنتائج كانت جزءاً منها بشكل لا فكاك منه، ولم تقلّ عنها ظلماً أو قساوة في تأثيرها في سكان الأرض التي استعمرتها.
هذه هي الحقيقة التاريخية التي أقام عليها (البندقية وغصن الزيتون) حُـجته المركزية. فالعنف المستمر في الشرق الأوسط يتخذ مظهراً مختلفاً تماماً عن ذلك الذي تسبغه عليه الأرثوذكسية السائدة، ولو عُريت جذوره لتبين كذلك أن أكبر عمل من أعمال العنف في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي (حرب الاستقلال الإسرائيلية) كان في الحقيقة عملاً واسع النطاق من أعمال التطهير الإثني قد قرره الصهاينة واستعدوا له منذ أن وطئوا أرض فلسطين.
الخرافة الصهيونية
وإن الرواية الصهيونية الرسمية التي تحيط بهذه الحادثة عبارة عن خرافة ذات أبعاد عملاقة؛ إنها خرافة تقول في صيغتها العامة -بحسب أحد الشعارات الشهيرة- إن فلسطين كانت أرضاً بلا شعب تنتظر شعباً بلا أرض؛ وإن الفلسطينيين، خلال الحرب التي اندلعت في العام ۱۹٤٨، فروا من البلاد بأمر من قادتهم؛ وإن الجنود اليهود، المخلصين لشعارهم “نقاء السلاح”، لم يرتكبوا أي مجزرة متعمدة ضدهم، وهزموا تحالفاً أقوى بكثير من الجيوش العربية كان ينوي تدمير إسرائيل؛ وإن الدولة الجديدة سعت بصدق بعد تأسيسها إلى تحقيق السلام مع جيرانها، ولم تلجأ إلى القوة المسلحة إلا دفاعاً عن النفس ضد إرهاب فلسطيني وعدوان عربي مستمرين وغير محفزين.
وكأي مشروع استعماري اعتمدت إسرائيل في وجودها نفسه على دعم راع إمبريالي أو متروبوليتاني. بل وبفضل الشتات اليهودي وتنوعه الجغرافي، استطاعت أن تتكل بشكل مميز على أكثر من راع. فقبل مرحلة الدولة، كان الراعي بريطانيا، القوة الإمبريالية الرئيسية في ذلك الوقت. بواسطة وعد بلفور للعام ۱۹۱۷، فتحت أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية ثم حمت المجتمع الاستيطاني المتنامي في صراعه الحتمي مع السكان الأصليين حتى أصبح قوياً كفاية ليتعامل معهم وحده. لكن بعد العام ١٩٤٨ انتقلت الرعاية أساساً إلى القوة العظمى الجديدة، الولايات المتحدة.
ولرعاية هذا الدعم والحفاظ عليه، كان على إسرائيل باعتبارها الدولة اليهودية، وعلى الصهاينة في كل مكان الاحتفاظ مهما كان الثمن بالرأي العام الدولي إلى جانبهم بالقدر الكافي وذلك لإبطال النتائج السلبية التي قد تصيبهم جراء الأخطاء المعنوية والمادية التي قد تنزلها إسرائيل -بوصفها مشروعاً استعمارياً- بالفلسطينيين.
وقد تميز ذلك منذ البداية ببراعة كبرى -لم يكن الفلسطينيون والعرب فاعلين قط في مواجهتهم إياه بسبب افتقارهم لأي تمثيل يقبل المقارنة ولو من بعيد داخل السياسة المحلية للراعي المتروبوليتاني- إذ إن عميد الباحثين الفلسطينيين، وليد الخالدي، يعطي هذا العامل أهمية فائقة في تاريخ الصراع بأسره. ففي الشرح الموجز ولكن المحترف لقيام إسرائيل الذي يرافق أنطولوجيته )من الموئل إلى الفتح( يقول: “إن العمى الجزئي الغربي في حد ذاته من معالم المشكلة الفلسطينية”. ولم يحِط “أي غموض بكيفية حصول ذلك”.
لم تتكشف المأساة الفلسطينية، فهي كذلك حقاً، في عصر غامض من عصور التاريخ أو في منطقة لا يمكن الوصول إليها عند أطراف العالم. فقد جرت في القرن العشرين خلال حياة آلاف السياسيين والدبلوماسيين والإداريين والجنود الغربيين وتحت أنظارهم، وفي بلد، في فلسطين، يسهل كثيراً وصول وسائل الاتصال الحديثة إليه. ولم تكن نتيجة تلقائية لظروف تصادفية وقوى خارجة على السيطرة. لقد أطلقتها أفعال إرادية متعمدة؛ فالقرارات الرئيسية التي أنتجتها اتُّخذت في عاصمتين غربيتين -لندن وواشنطن- ومن قِبل قادة دستوريين… وقد اتُّخذت هذه القرارات بوجه الحقائق القائمة في فلسطين وبوجه المناشدات المعذبة لعرب فلسطين والتحذيرات والنصائح للمراقبين الخبراء الغربيين… لم يكن الفلسطينيون أول شعب يتعرض للحرمان والنفي ولن يكونوا الأخير؛ لكنهم إلى اليوم الوحيدون الذين لا تكتفي المحكمة الغربية بردّ نكبتهم بدعوى أنها غير ذات صلة بردود فعلهم ضد مرتكبي النكبة، بل إنها تعتبرهم كذلك مجرمين بسبب ردود الفعل هذه. لقد شكل هذا العمى الجزئي الغربي نفسه الجو اللازم لتحقيق المشروع الصهيوني.
تعزيز الخرافة الصهيونية فضيحة جوان بيترز
لا يزال العمى الجزئي قائماً إلى اليوم وكذلك الحاجة إليه، أو بالأحرى للتحيز الذي هو ابنه بالتبني. لقد أصبحت إسرائيل أقوى بما لا يقارَن مما كانت عليه سابقاً، لكنها لم تصبح أقل اعتماداً على راعيها المتروبوليتاني من أي وقت مضى، وتحديداً على النفوذ الهائل الذي اكتسبته عليه، إما مباشرة أو بالتنسيق مع “أصدقاء إسرائيل” في الولايات المتحدة.
وهذا بدوره يجعلها تعتمد على احترام الرأي العام الأميركي ككل والذي يشكل في نهاية المطاف السياسة الأميركية الخارجية أو يردعها عن سلوك مسالك لن يقبلها. ويمكن طبعاً للموقف الإسرائيلي أن يؤثر في قضية سياسية مباشرة، لكنه في شكله الأعمق والأبعد مدى يسعى إلى الحفاظ في نظر الأميركيين على استقامة المشروع الصهيوني وأسسه المعنوية.
وشهدت هذه الأرثوذكسية السائدة بعض التآكل منذ (صدور البندقية وغصن الزيتون) على الرغم من أن دوره في هذا الاتجاه كان صغيراً جداً. لكن مقدار القوة التي بقيت لها، أو بالأحرى مجرد مقدار الفاعلية والتلقائية اللتين كان يتعبأ بهما المثقفون والأكاديميون ووسائل الإعلام وصناع الرأي في مجملهم للدفاع عنها، تبين بوضوح كبير جداً مع ظهور کتاب آخر بعد سبع سنوات لقي استقبالاً مختلفاً تماماً مقارنة بكتابي. ففي العام ١٩٨٤ نشرت جوان بيترز كتابها: (منذ الأزل: جذور الصراع العربي – اليهودي على فلسطين).
وقد عمد هذا الكتاب، ليس فقط إلى الدفاع عن الأرثوذكسية والحفاظ على خرافتها، بل كذلك، وعن طريق استعراض ضخم من البحث والتقميش، إلى جعلها غير قابلة للاختراق. كان من الأمور المتعارف عليها عموماً منذ العام ١٩٤٨ أن اللاجئين الفلسطينيين الذين خلقهم قيام إسرائيل هم لاجئون حقاً، بغض النظر عن قراءة المرء للأحداث التي أفضت إلى ذلك. لكن بيترز، الباحثة الأكاديمية، وبعد دراسة الأوضاع الديموغرافية واتجاهات الهجرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ادعت عدم وجود هؤلاء؛ فهم لم يقيموا في فلسطين “منذ الأزل”، ولم يكونوا في الواقع أكثر تجذراً في الأرض مقارنة بـ”المهاجرين” الصهاينة الذين تدفقوا إلى فلسطين منذ صدور وعد بلفور. لقد كانوا هم أنفسهم “مهاجرين”. ومعظم ما يُسمَّى باللاجئين كانوا في الواقع قد أتوا إلى فلسطين في السنوات القليلة السابقة. وقد جذبهم إلى هناك الازدهار وفرص العمل التي خلقها المهاجرون الآخرون الصهاينة الذين تفوقوا عليهم لناحية الكد والفاعلية والاستثمار، وأصبحوا نتيجة لذلك يملكون حقاً في أرض فلسطين مساوياً لحق الفلسطينيين “الواصلين حديثاً”، إن لم يبزّه، ولو أنهم في الأصل من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
لقد شكل ذلك فعلاً أطروحة جديدة وثورية، أطروحة مدهشة وفريدة فاتت كل باحث أو صحافي أو رحالة، سواء أكان صهيونياً أم معادياً للصهيونية، كان قد تعامل مع الموضوع خلال السنين المائة السابقة. أطروحة كانت في حال صحتها كفيلة بتقويض القضية العربية والفلسطينية بضربة واحدة. بل إن أي باحث أو دعائي لم يعد بمقدوره أن يجادل بأن الفلسطينيين في الواقع شعب حقيقي وبأن لهم تاريخاً حقيقياً في «فلسطين»، بحسب الناقد والمعلق الفلسطيني المميز إدوارد سعيد. “لقد أكد كتابها أن وجودهم الوطني، وكذلك وجودهم بحد ذاته، وبالتالي دعاواهم في وجه إسرائيل، باتت في أفضل الأحوال محاطة بالشكوك وفي أسوأها مجرد اختراع… فالفلسطينيون هم عبارة عن دعاية كما كان شأنهم دائماً”.
هذه النقطة تحديداً كانت مهمة بحد ذاتها في ما يتعلق بالصراع وبالموقف الذي كان يجب أن تتبناه الولايات المتحدة. وعلى هذا النحو رآه على الفور حراس الشعلة الصهيونية ومعهم المؤسسة السياسية-الثقافية برمتها تقريباً. وأصبحت (بيترز) بسرعة نجمة، وانهالت عليها طلبات الظهور في برامج الحوار الإذاعية والتلفزيونية، وقد وافقت على المشاركة في نحو مائتين وخمسين برنامجاً في العام ١٩٨٥ وحده. وحققت تحفتها نجاحاً نشرياً مباشراً. وفازت بسرعة بجائزة الكتاب اليهودي القومي المرموقة. وطبعت سبع مرات خلال ثمانية أشهر من صدورها للمرة الأولى، وقد لاقت كل طبعة التمجيد من قبل أهم المراجع، من المؤرخة الشهيرة بربارا توكمان التي أسمت الكتاب “حدثاً تاريخياً بحد ذاته” إلى الروائي سول بيلو الذي قال: “إن ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم، المضللين بتاريخ ودعاية زائفين، سيكونون ممتنين لهذه الرواية الواضحة لأصول الفلسطينيين”.
وراجعت الكتاب دوريات الرأي المهمة كلها تقريباً. وقد توحّد النقاد في الدهشة من المستوى الملحمي والشمولية والدقة -تكررت هذه الصفة كثيراً- التي ميزت بحثها ودراستها. فقد رأى رونالد ساندرز، واضع دراسة ضخمة حول وعد بلفور، أن الأوضاع الديموغرافية التي تناولتها يمكن أن تغير كل الجدال حول فلسطين. وأعلن مارتن بيريتز، محرر النيو ريبابليك، أن العمل “سيغيّر رأي جيلنا، ولو لقي الفهم المناسب، فقد يؤثر في تاريخ المستقبل”.
وتساءل إدوارد سعيد: كيف أمكن في الولايات المتحدة، القلعة الفعلية لحرية التعبير والنقاش الصحيح “أن ينجرف محررون ومؤرخون وصحافيون ومفكرون بارعون في العادة في خرافة أن (منذ الأزل) عمل رائع من أعمال الاكتشاف التاريخي”؟ هل وصل الأمر إذَن إلى أن تسمح عقيدة يحملها اللاوعي لأكثر الأكاذيب فضائحية وإثارة للتقزز -رديئة الكتابة، فوضوية تماماً، مؤكدة بأسلوب هستيري- بأن تمر بوصفها بحثاً فريداً وحقيقة واقعة واستشرافاً سياسياً من دون أن تواجه ما يجدر ذكره من التشكيك أو الاعتراض أو حتى التحفظ المهذب”؟
هذا ما حصل. فحين يتعلق الأمر بفلسطين، تختلف الولايات المتحدة إلى حد كبير عن أي مكان آخر في العالم، بما في ذلك حليفتها الأنكلو-سكسونية الأقرب: بريطانيا. بل وحتى المستفيدة على ما يبدو من هذا التحيز شبه الأعمى، إسرائيل نفسها. إن النفوذ الذي حققه صهاينة بريطانيا حين كانت هذه الدولة، بوصفها القوة المنتدبة في فلسطين، تلعب دور الراعي المتروبوليتاني المقرر بالنسبة إلى حظوظهم، كان نفوذاً مذهلاً دائماً، لكن مظهره تضاءل بالمقارنة مع الإنجازات التالية لصهاينة الولايات المتحدة. لذلك لم يكن غريباً أن يواجه منذ الأزل هجوماً سريعاً ومذلاً فور صدوره في بريطانيا.
فقد استنتج ألبرت حوراني، مؤرخ الشرق الأوسط البارز، أن الكتاب كان “مضحكاً وعديم القيمة”، مؤكداً أن المسألة المثيرة للاهتمام إلى حد ما فيه تمثلت في قدرته على كسب المدائح التي كسبها على الضفة الأخرى للأطلسي. ووصفه السير أيان غيلمور ودافيد غيلمور في مقالة مشتركة من ثمانية آلاف كلمة في اللندن ريفيو أوف بوكس بـ”المحال”. وفي إسرائيل شبهته صحيفة (دافار) الناطقة بلسان حزب العمل بالممارسات الدعائية الأكثر مدعاة للندم التي كانت البلاد قد عرفتها قبلاً. ووصفه أفيشاي مرغليت، رئيس دائرة الفلسفة في الجامعة العبرية “بشبكة الخداع”.
في هذه الأثناء، وفي الولايات المتحدة نفسها، ولأسباب عدة، من بينها السخرية الخارجية، راح الترحيب الذي أُغدق برياء على العمل العظيم يتحول إلى إحراج كبير، وإلى فضيحة أدبية محتملة، لم تفُقها في الأزمنة القريبة سوى السيرة المزيفة التي وضعها كليفورد إيرفينغ للناسك الملياردير والغريب الأطوار هوارد هيوز.
في البداية لم تجرؤ سوى المطبوعات المتطرفة أو المغمورة على انتقاد الكتاب. ففي الأسبوعية السياسية الصادرة في شيكاغو (إن ذيس تايمز) كتب الباحث نورمال فنكلشتاين، الذي كان قد بدأ يصنع اسمه كناقد لاذع للمؤسسة الصهيونية، نقداً مدمراً لم يستهدف (أطروحات) بيترز فحسب، بل كذلك الكم الهائل من الأبحاث التي أجراها آخرون بناء عليها. واستنتج أن أبحاثها لم تكن مباشرة أو فريدة أو دقيقة، بل مجرد غرق في قنوات الدعاية الصهيونية خلال نصف قرن. وكانت النتيجة “أحد أكثر أعمال الخداع إبهاراً المنشورة حول الصراع العربي-الإسرائيلي”. وأضاف أن العمل “لا يتميز في حقل مليء بالدعاية والتلفيقات والتزييفات السافرة”.